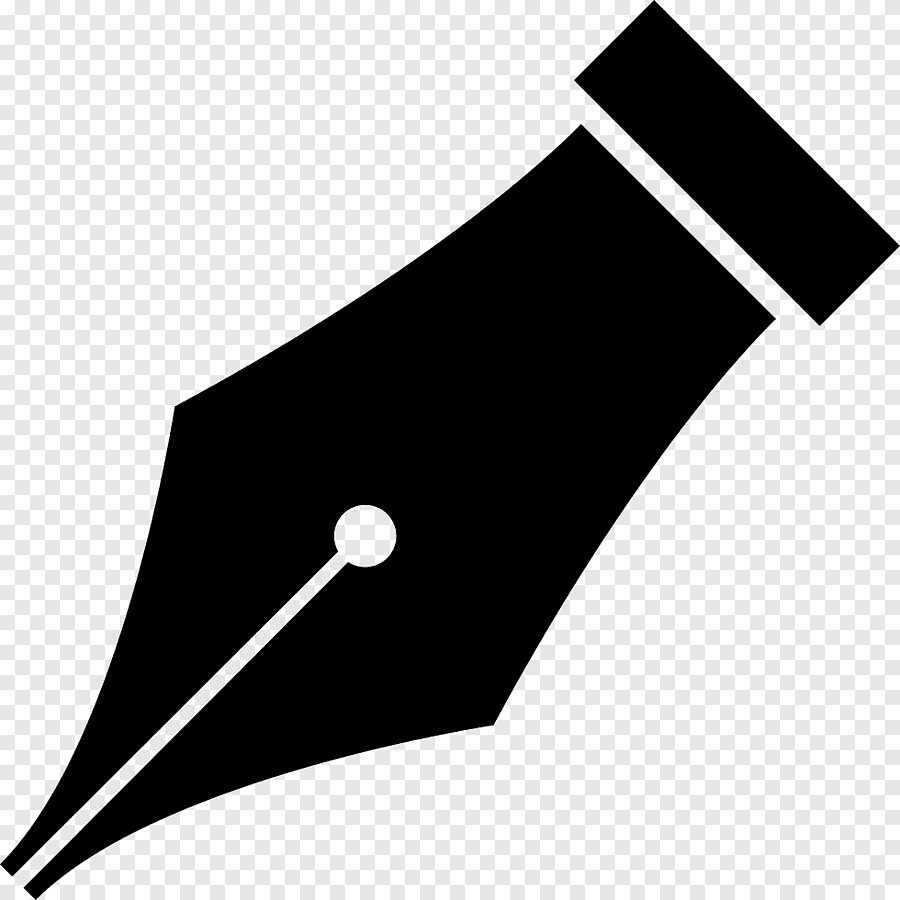تنور البادية .. و جبل الأفندية
في صراعها اليومي مع الحياة، تتمحور البشرية بالقرب من المصادر المائية و حول ذلك دارت العديد من المعارك، لذلك اتخذ المستعمر مرقده عند مجمع البحرين. و مع تطاول أمد الإستعمار، نمت الحاجة للأيدي العاملة للمساعدة في تسيير دولاب الدولة، فلم يجد المستعمر بدا من “تمدين” مراكزه. فأنشأ المستشفيات، السكة حديد، المعاهد والجامعات ليخدم أجندته الخاصة في المقام الأول. وبذلك تركزت الخدمات علي ضفاف النيل مع تخوم العاصمة.
في كنف هذه البيئة المحفوفة بثكنات (قشلاك) الجيش و الشرطة، نمت طبقة سياسية “كافأها” المستعمر بأن اوكل اليها أمر إدارة البلاد بعد أن قرر الخروج، تاركا خلفه نظاما سياسيا مركزيا قابضا، يخول للحاكم العام التصرف في كل شبر من البلاد من قصر غردون. يركز هذا النظام كل السلطات والوظائف والامتيازات في المركز، فيفرض ضرائب الدقنية، يصدر نوابه لحصد الدوائر الانتخابية، ينهب عائدات الأقاليم من زرع و ماشية، يجند المليشيات، و يغدق العطايا للمؤلفة قلوبهم لتثبيت أركانه. وبذلك يظل الحديث عن وقف الانقلابات عن طريق الإكتفاء بتدوير أسماء دون تفتيت تركيز هذه السلطة، محض أضغاث أحلام.
و سعياً للتوطيد سلطتها، لم تجد هذه الطبقة السياسية بدا من إعمال شعار فرّق تسد باستثارة ما أُطّر لاحقا بعنف البادية. فبذرت نطفة قوات المراحيل، لضرب قبائل التماس ذات “العقل الرعوي” مع الجنوب. ثم تخلّقت هذه النطفة إلى علقة حرس الحدود وبلغت أشُدها في هيئة ‘الدعم السريع”، ولم يكن الهدف من كل ذلك، سوى شغل الأطراف بصراعات محلية تصرفهم عن التفكير في القضية الرئيسية المتمثلة في تفكيك منظومة المستعمر، وتأسيس الدولة الوطنية. هذا حميدتي مثلا، بكل ما اقترفه في دارفور من جرائم، لم يكن يملك طائرة ورق، لكن جهة أخرى تمتلك سلاح الطيران هي التي قصمت ظهر دارفور، و جبال النوبة و الجزيرة أبا، بالأنتنوف والقنابل العنقودية، ولم تبخل عليهم بالكيماوي، وارتكبت المجازر في عنبر جودة، واو،جوبا، والضعين وجهرت بأن تستورد قنابل نيبالم تثبت بها سعر جوال الفحم لعقود.
كان واضحا أن تحالف قوى الحرية و التغيير يفتقر لأبسط مكونات التجانس، و استنفذ اغراضه عشية سقوط البشير. ويتجلى ذلك في ان بعض عناصره أقرب اجتماعيا واقتصاديا للعسكر، من كيانات أخرى داخل التحالف نفسه. لذلك جاد مفاوضوه بتنازلات للعسكر شق عليهم تقديم معشارها لنظرائهم في ذات التحالف. و ما ان تبدت الصور الأولى للقاء إنجمينا بين الخارجين على هذا النادي حتى تأبطت عصبة الحرية والتغير شراً صوب أديس أبابا (مرة أخرى)، لقطع الطريق على اي تقارب في إنجمينا. وفي تكرار لشريط مؤتمر المائدة المستديرة ١٩٦٥، وبعد أسابيع من المحادثات، تلا أحد أحفاد ميشيل عفلق بيانا أكد فيه توصلهم لاتفاق مع “أندادهم” بخصوص هيكلة الفترة الانتقالية. لكن ما ان حطت الطائرة في مطار الخرطوم، حتى تنصل الملأ من الإتفاق. بل واصلوا الليل بالنهار لتضمين بنود في الوثيقة الدستورية، تُحجم صلاحيات اي اتفاق سلام قادم. ولم تفلح لقاءات القاهرة بعد ذلك في الإبقاء على شعرة معاوية.
لم يتوقف خبث الدولة العميقة عند هذا الحد. فبعد محاولات عديدة يائسة للمشاركة في مفاوضات جوبا، كرر الأفندية استنجاد عبد الله خليل بالفريق عبود، فتدثروا خلف عباءة العسكر في “المجلس الأعلى للسلام”، سعيا لامتلاك “فيتو” للالتفاف على بند سيادة اتفاق السلام على الوثيقة الدستورية. و يبلغ الاستقطاب مداه هذه الايام، بالسعي لفرض واقع جديد يستلحق الآخرين بالإصرار على الانفراد بقرار تعيين ولاة في أقاليم شاركت أحزابهم حكومة “الوحدة الوطنية” في دكها بالميج والسوخوي.
هذا ليس سلوك بلد يعاني من إبادة جماعية و لا يبدو أن من اختطفوا دفة الثورة قد فقهوا شيئا من استقلال الجنوب. ولو بُعث أحد موتى ١٩٦٤ او ١٩٨٥ ليطالع عناوين صحف اليوم، لتقاسم بالله انه ما لبث غير ساعة. لم تستعر الحروب لمنازلة شخوص الأنظمة السابقة، بل ضد ظلم ممنهج من قلة ظلت تختطف قرار البلاد و”تمنح” الأقاليم زكاة حقها بمعشار نصف العشر من أصل 800 وظيفة تركها المستعمر.
هذه الثورة التي إنطلقت منذ عقود، ليست ضد العسكر او الأيديولوجيا، بل تحمل في لبها صراع إجتماعي طبقي بالغ الإحتقان، غذته مظالم متكدسة لستة عقود بين الغالبية الساحقة من البادية ضد أقلية إجتماعية من المدينة. جوهر الثورة هو تحرير أقاليم السودان من صلف جمهورية الخرطوم عن طريق قلب الهرم الذي تقرر فيه ثلة قليلة مصير السواد الأعظم من القاعدة. لم تعد المعرفة حصرية على أفندية مؤتمر الخريجين بروافده المحدودة. فقد هاجر الناس بين المشرقين، و دخل بعض من أفلت من حمم الأنتنوف وقرش المتوسط الى جامعات و حضارات العالم الخارجي، واتسعت مداركهم للحقوق و الواجبات. لن يقبل أحد بتمثيل مفصّل وفق أهواء المانحين الجدد، ولن يستقر السودان ما لم تكن الأولوية لأولئك الذين دفعوا ثمن حروب الإبادات المستمرة، و سكنوا معسكرات النزوح و اللجوء. وان كانت هذه النخبة التي أدمنت الفشل، وأدخلت السودان هذا النفق المظلم، تأوي إلى جبل العسكر في كل مرة ليعصمها من طوفان استحقاقات الهامش، فقد فار التنور هذه المرة، و بلغ الحنق حدا لن تجدي معه مسكنات الألم التي أستُعملت في ١٩٦٤ و ١٩٨٥. فقد قدمت الديموقراطية على السلام في ثلاث مناسبات مفصلية، ولم يلد ذلك الا إبادة جماعية و انفصال مولم. ربما أمكن القدر وزير داخلية ذاك النظام الطائفي من التنكيل باعضاء جبهة نهضة دارفور في عهد ديموقراطية عرجاء. بيد أن تعاظم المظالم حوّر تلك المذكرة الاحتجاجية من مجرد ورقة، الى مدافع ثقيلة لن تنتظر أن يفرغ أفندية الخرطوم من غمرة صراعهم على السلطة ليرموا لها ما تبقى من فتات.
ختاما، شُيّد الاتحاد الأوروبي، اكبر سوق مالية مشتركة في العالم، على أنقاض نورماندي، بعد حرب ضروس استمرت لأربعة قرون، قضى فيها أكثر من ثلث أوربا. و توحدت أمريكا بحد سيف لينكولن. ولا يختلف الأمر كثيرا في تسع دول تجاور السودان. ها قد دنت للمرة الرابعة فرصة ذهبية قد لا تتكرر لوقف رحى الحرب الى الأبد. و خير لنا ان نبدأ من حيث إنتهى الآخرون، بدل أن نسلك دربا طويلا لنعود و نبدأ من حيث نحن، فكرونا عسكرية هي آخر ما تحتاجه بلاد تفتك بها الكرونات الصحية و الاقتصادية. لكن الحقيقة النافذة انه وبعد ستة عقود من الاستعمار الوطني، قد وصلنا الى خيارين لا ثالث لهما: اما السلام الشامل، أو الانهيار الكامل.
فاروق جبريل
أبريل ٢٠٢٠